الإشكالية الثانية: “المراهقة المهملة ودورها في تهيئة الفرد العازف عن الشأن الفكري”
حاولت المتحدثة “نوري هاجر” عبر مداخلتها تسليط الضوء على فترة المراهقة كمرحلة تزخر بالتَّمهيدات المرتبطة بظاهرة عزوف الشَّباب الجزائري عن الشَّأن الفكري، وانطلقت من الإشارة لتحدي التَّعامل مع هذه الفترة وظواهر التَّسرب الحاصل كتحدٍّ فكريّ بالدّرجة الأولى.
وانطلقت من مساءلة مفهومها ضمن جهازنا المعرفي ووقفت عند اشكالية اضطراب المصطلح، وفي محاولة لتحريره اعتمدت طريقة تتبعه التَّاريخي في اللّسان العربي، في القرآن السنة والآثار وموازاةً مع تاريخ نشوئه في اللّغات الأخرى وتحديات الترجمة والنقل، إذ لا يمكن الخوض في مفهوم كالمراهقة دون الولوج على قضية نقل المصطلح ذو الدلالة المتجذرة في تشكيل حضاري فريد له لغته وخصائصه إلى لغة وثقافة أخرى، إيمانًا بضرورة العناية بتنقية معارفنا النَّفسية والتَّربوية من آثار الاستلاب باهتمامنا بتحديد المحيط الدلالي وكذا ضبط علاقة الدال بالمدلول مع مراعاة الشروط التداولية لكل من اللغة الاصل واللغة المستقبلة.
فـ”المصطلح الوافد في العلوم المادية برئ حتى تثبت إدانته والمصطلح الوافد في العلوم الإنسانية ظنين حتى تثبت براءته”
ثم كان السؤال ماذا بعد تحرير المصطلح ؟
يعكس الخطاب العام اليوم بعض ملامح نقد مفهوم المراهقة في شكلها المعاصر كخطوة تلي تحرير المصطلح تحوي اعترافًا ضمنيًا بضرورة إصلاح نظرتنا لهذه المرحلة في جهازنا المعرفي وجعلها ضمن المفكر فيه، لكن مساعي التّغيير تتوقف على أعتاب هذا الاعتراف الذي يكتفي غالبًا بإلغاء خصوصية المرحلة كحل راديكالي لإشكالية غيابها في التّراث مثلا ويظهر هذا بإنتاج خطابات الاستشهاد بنماذج تاريخية كمثال، وهو خطاب ينقل مفاهيم من سياقات تاريخية مختلفة وبذلك فإنه لا يراعي واقعنا وتحدياته الجديدة ويختزل ما يزخر به تراثنا في موضوع المراهقة في شكل خطاب وعظي بعيد عن أي فاعلية أو تأثير
ومن هنا أشارت المتحدثة لأهمية محاولة فهم المتلقي وسياقه (كما هو كائن قبل كما يجب أن يكون) قبل الانطلاق في إنتاج الخطاب الفعَّال الموجه إليه أو المعبّٓر عنه، بتسليط الضَّوء على تأثير تشكُّل مفهوم المراهقة على التَّركيبة الذهنية المجتمعية، وخاصة السّياق المرافق لهذا التشكل، مع محاولة رصد التغيرات الحاصلة على مفاهيم أساسية لدى المراهق كالنضج والمسؤولية ومحاولة ضبط العلاقة الجدلية بين الذهنيات والنموذج.
عرضت المتحدثة بعض نتائج استبيان حاولت فيه الاقتراب من هذا المراهق للتركيز على مسار تشكل بعض الصفات لديه، حيث أشارت إلى وجود مُفارقة واضحة بين تصوّر المراهق لذاته كشخص مسؤول وغياب ما يفعّل هذا التصوّر في الواقع.
في الختام طرحت المتحدثة تساؤلا عن ملامح اهتمام أصحاب المشاريع التربوية أو الاصلاحية بهذه المرحلة، وأرفقتها بإشكالية الأدوات والوسائل وكذا العقل الذي يتعامل مع الوسيلة، ومدى قدرتنا على تجاوز الذهنيات المحجوزة داخل فقه استدراكي يعزلنا عن وسائل العصر، ويؤخر قدرتنا على رؤية ثقلها ضمن معادلة التغيير.








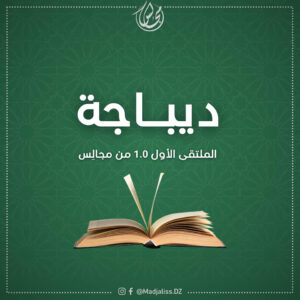

لا توجد تعليقات بعد