يختم المتدخل ورقته بالتذكير أن معركة الإنسان المعاصر اليوم هو اكتشاف من يصنع له المعنى؟ من خلال هذا يدرك الإنسان تمثل المسؤولية في واقعه، وبعدها كيف يجب أن تكون؟ فالتفكير نشاط جماعي و فاعلية مشتركة، وكل تفكير يقتصد في بنائه على منظومته الذاتية، مقطوع الصلة بحاضنته الجماعية، محكوم عليه بالفشل والزوال ، هنا لابد أن تتشابك النخب أولاً، قبل/من خلال الحديث عن التشابك مع المجتمع، لابد للنخبة أن تجد الخيوط الناظمة لها من خلال انتمائها الهوياتي، رغم اختلافات توجهاتها، فرهان اليوم ضبط / تكوين / تأهيل نقاط القوة في خطاب/رؤية يواجه تحديات الخطاب الاستهلاكي وثقل خطابات المجتمع التي تكون شخصية الفرد وتصنع له المعنى و توجه له المسؤولية، الرهان إذن في صناعة مؤسسات موازية للمعنى تحجم الأزمات التاريخية وتعطي مكانة للأولويات، حفظ هوية الإنسان بما هو فطرة أولاً، و كونه ذا هوية لها أبعادها المبدئية و الاجتماعية الواقعية.
الإشكالية الثالثة من الجلسة الأولى “الاعتزال الطّوعي للمسؤوليّة عند الشباب الجزائري: مقاربة حول محفزات الحس العبثي ومشاكل الواقع الجزائري” يحاول من خلالها طالب الدكتوراه “زين العابدين لبيوض” تجلية مشكلة تلاشي جاذبية القيم المؤسسة لفكرة المسؤولية كما يجب أن تكون لا كما هي في المخيال الاجتماعي، عبر النظر في تمثلات المزاج العبثي باعتباره شعوراً اجتماعيًّا و نمطًا سلوكية عند الأفراد والمجتمع ، مسلطًّا الضوء على أهم العوامل التي ساعدت في تعزيز وتثبيت هذا المزاج في واقع استهلاكي.
في ظلِّ الإشكالية الكبرى للملتقى، يشير المتدخل إلى مشكلة منهجية ونفسية في التعامل مع الواقع، إذ إنّ رهان اليوم هو في البحث عن الكلمات المناسبة كما يقول ميشال ميزوفيلي، في تجلية ما أمكن من التحليل لواقع الشباب الجزائري كونه فردًا أو جماعة لها خصوصيات و ظواهر مرصودة مع عوامل ومحفزات ترتبط بها، إضافة إلى وجود ما يشتبك مع السياق العالمي و مؤسساته، بعيدا عن الانطباعات الشخصية والانتمائية، أي تلك التحليلات التي ترتبط برغبة توجهها في سؤال : كيف هو الواقع؟ فضلا عن كيف يجب أن يكون؟
يلاحظ الدّارس للواقع الجزائري وخصوصياته ضعف أكثر الدراسات حوله والتي لا تصل عادة إلى ذلك القدر من الدراسة المنهجية السوسيولوجية الجادة، إضافة لذلك نجد أن أغلب الدراسات تُعالج الشباب كشريحة واحدة متغافلة عن الاختلافات الموجودة بين فئاته والتي يفرضها الواقع، وفي ظل هذا نجد إشكالية في التعاطي مع المفهوم، وبالتالي في سلاسة إسقاطه مباشرة على الواقع الجزائري.
إن المزاج العبثيّ مرتبط أساسًا بإجابة سؤال “ما هو المعنى؟ وبالضرورة من يحدده؟” قد نجد أبرز من تعاطى مع السؤال مباشرة بمحاولة نسقية هو سارتر ليجعل للذات سلطة صناعة المعنى. فإن الواقع الاستهلاكي اليوم يفرض إجابات أيضا لكنها بأنماط أكثر مستغلا خاصية الإنسان النفسية الطبيعية {اهتمام الفرد بصورته المرسلة في الفضاء العام}، في حين، نجد سؤال المعنى بسياقه السابق غائبًا عن ذهنية الشباب الجزائري في مجتمعه فضلا عن غيابه عن محاولات تسعى لتأسيس رؤى إصلاحية، فالسؤال بدوره يشكل قاعدة معرفية و اجتماعية لما بعده أي: ماهي المسؤولية ومن يحددها؟ في ظل تغلغل الفردانية بصورتها النرجسية، نشير أنّ هذا المزاج عرض لا ينفك أيضا عن تراكم لأمراض أنثروبولوجية و اجتماعية، أبرز لوازمه ما يركز عليه بن نبي بانفصال الفكرة عن الواقع.
لينتقل بعد ذلك إلى عرض تمثلات المشاكل التي أدّت إلى الاعتزال الطوعي التي يمكن تلخيصها في ما يلي:
بعدها تحاول الورقة البحثية الربط مع عناصر تعتبر محفزات لذلك الحس العبثي:
يشير المتدخل إلى اختلاف تلك المحفزات والعوامل المساهمة في تجليات العزوف عن المسؤولية عند الشباب -مع اشتراكهم في أنماطها-على الذات وفي الواقع :






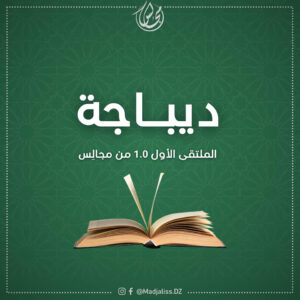

لا توجد تعليقات بعد