الجلسة الثانية: الشأن الفكري والتقاليد الثقافية.
افتتحت الجلسة بالحديث عن إشكالية “المجتمعات الشفوية ودور الكتابة في الشأن الفكري”.
المداخلة تُلخِّص رحلة الدكتورة [منال بوخزنة] في محاولتها الإجابة عن الإشكالية التي بدأت تتشكل معالمها منذ فترة الثانوي حول المجتمعات الشفوية: ما معنى المجتمعات الشّفوية وهل يُعتَبر مجتمعنا من ضمنها وما علاقتها بعزوف الشباب عن الشأن الفكري ؟ وانطلقت في بحثها من فرضية وجود مجتمعات شفوية أكثر منها كتابية ومايمكن أن يترتب عن ذلك من أسئلة:
هل غلبة الشفهية تجعل المجتمعات أقل تأليفاً وبالتالي أقل إنتاجاً علمياً.. وهل قلة الإنتاج يقود إلى قلة الإطلاع على الشأن الفكري؟
أين قسمت الإشكالية إلى ثلاث محاور مرتبطة بعلاقة مثلثية :

العلاقة بين الظاهرة الشفاهية والكتابة

العلاقة بين الكتابة والشأن الفكري

العلاقة بين الشفاهية والشأن الفكري

– محور الشّفاهية والكتابية:

يُمثّل ضبط المفهوم نقطة مُهمّة في الإحاطة بالموضوع ابتداءً من مفهوم الشفهية البدائية مُمَثّلا بالمرحلة التي سبقت ظهور الكتابة ومُوثَّقا بإنتاجات شفهية تنتمي لتلك المرحلة منها ملحمة هوميروس.. يليه مفهوم الشّفهية الثانوية التي عادت بعد ظهور الكتابة.

ثُمّ تناولت بالبحث عرب الجاهلية واعتمادَهم الواضح على الشفاهية على الرغم من وجود الكتابة ثمّ الانتقال الواضح للكتابة بعد ظهور الاسلام الذي جاء بالحثِّ على القراءة وكتابة الديون، مع ارتباط الكتابة بالاحتياج لتأسيس الدولة وتنظيمها مع توسع رقعتها وكذلك الاحتكاك بالحضارات الأخرى، مع استمرار الشفهية كظاهرة تتجلى من خلال الطرق الإسلامية في التدريس كالتلقين والإلقاء مثلا. وهذا ما مهّد للسؤال حول طبيعة علاقة الشفهية بالكتابة، واستنتجت أنها كانت علاقة احتياج لتأسيس الحضارة حيث لم تكن الشفاهية كافية بذاتها.

والحديث عن الظاهرتين، يجعل السؤال ينعقد بالضرورة حول الفرق بين العقل الشفهي والكتابي، وطبيعة ونظام عمل كل منهما ومتطلباته، فقد تحتاج المجتمعات الشفهية اعتمادا أكبر على الذاكرة مما ينعكس على تبسيط شكل المعلومة وصياغتها الإيقاعية الأسهل للتداول والحفظ .. أمّا في المجتمعات الكتابية النص موجود ومحفوظ وهذا ما يسمح للعقل بتشعّب الأفكار وتوسعها. وهذا كان على سبيل المثال، في الحديث عن الديناميات النفسية للشفاهية وعقد المقارنة.

وربطت الأمر بمجتمعاتنا الجزائرية خصوصا فترة الاستعمار الفرنسي التي تمثل محاولات محو للهوية الجزائرية العربية الإسلامية حيث قد تبدو تلك الفترة تأسيساً لبروز الظاهرة الشفوية بسبب غلبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حيث اقتصرت اهتمامات الفرد على حفظ الحياة وكسب القوت وهذا ما جعله بالضرورة شفهيا أكثر.. كما أنه من السهل ملاحظة أن أكثر الفئات الصامدة هي الفئة التي دعت للإدماج ومثلته، إذ استمرت كتيارات ذي توجهات فرنسية لأنها تيارات كانت تتلقى تعليما كتابيا.. أي أن الجماعات التي أزيحت عن المسار العلمي هي جماعات شفهية أكثر والجماعات التي تلقت تعليما كانت قادرة على الاستمرار من خلال المؤلفات والكتب.

– علاقة الكتابة بالشأن الفكري:
يدرس هذا المحور العلاقة بينهما باعتبار أن الحضارة تقوم على العلوم فتوثيق تلك العلوم -أي الكتابة- لها دور في قيام الحضارة ودور أساسي في الشأن الفكري.

– علاقة الشفاهية بالشأن الفكري:
يبحث هذا المحور ظاهرة صعود الشفهية الثانوية مع وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والمرئية..ويطرح السؤال عن قوة المجتمعات الشفوية وهل هناك عزوف عن الشأن الفكري إذا كان للشفهية في شكلها الجديد سلطة وتأثير.
وفي النهاية يظل سؤال الفرضية الأول قائما، وهو ما يحاول المقال الإجابة عنه بشكل أكثر تفصيلا وإلماما.






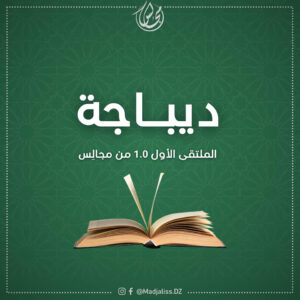

لا توجد تعليقات بعد