بقلم الأستاذ د. محمد عبد النور.
على هامش منتدى مجالس.. جدل المثل الفكرية-الخلقية والهويات الطبيعية في الجزائر
بداية، فليسمح لي الإخوة في “منتدى مجالس” مشاركتهم البحث في إشكالية “عزوف الشباب الجزائري عن الشأن الفكري”، -التي تعذر عليًّ تلبية الدعوة للحضور الفعلي في ندوتها- مشاركة افتراضية تكون تعويضا عن الغياب، وكذا -وهو الأهم- إسهاما في النقاش وإثراءً له، وهذا من باب الواجب الفكري والأخلاقي، ولأن في مبادرة “مجالس” ما يبشر بخير ثاوٍ بين جنبات المجتمع في هذا الوطن الفسيح… لأدخل في عرض فكرتي مباشرة، من المهم أن نسأل بداية عن المقصود بالشأن الفكري؟ وهل أن العزوف عنه أمر حاصل فعلا لدى الشباب الجزائري؟
من بين الدلالات التي قد تشير إليها عبارة “الشأن الفكري” الانشغال بقضايا الشأن العام الواقعية والفكرية، كالتزام أخلاقي ومحاولة ارتفاع إلى مستوى الأفكار، بدل الانهماك في شؤون الحياة المادية الفردية والانغماس في متع الترفيه التخديرية وتناسي المشكلات الحقيقة التي تواجه الإنسان الجزائري، ولهذا أهميته فهي تجعل الإنسان دائم السؤال والبحث، وهذا ما يمنحه أفقا للرؤية وانفكاكا عن المادية الصرفة والإخلاد التوثيني للحاصل من الوقائع المادية والرمزية(1).
أما عن معنى ودلالة الشأن الفكري لذاته فهو أقرب إلى كونه استجابة لنداء الفطرة أو الضمير، بما هو صوت خافت يصدر من أعماق الذات الإنسانية في مواجهة التحديات الزائفة التي تطرحها الحياة المادية، أو حتى تلك التي تطرحها المنظومة التاريخية ذات الأبعاد: الثقافية والاجتماعية والسياسية السائدة، أعني أن العناية بالشأن الفكري ذات شقين أساسيين هما:
1- التمرد على متطلبات الحياة المادية، بما هو إنكار فطري للتعلق بها كأولوية حيوية، ودحرجتها إلى مرتبة أدنى في سلّم مقومات الوجود الإنساني.
2- التمرد على متطلبات النظام التاريخي، بما هو إنكار فطري للاحتكام إلى نموذج تاريخي سائد، باعتباره مجرد معطى مؤقت لا يعبر عن جوهر الوجود الإنساني.
وعن العناية بالشأن الفكري تنشأ مختلف مظاهره المعبرة عنه والتي تختلف في عمقها من شخص إلى آخر، قد يكون منطلقها متابعة الشأن السياسي من أحداث ووقائع وتطوراتها، وقد تكون غايتها متابعة الشأن المعرفي من أفكار وأطاريح حول الواقع الوجودي المُعاش، و ما بينهما مما يتخلله من انخراط في الواقع بما هو أنشطة ومشاركات في الفضاء العام الواقعي منه والافتراضي.
لكن لابد من التنبه إلى تمييز مهم بين العناية بالشأن الفكري بوصفه حالة من الاشرئباب إلى معايشة عالم الأفكار وبين الهم النضالي بما هو حالة فوران شبه دائمة تستجيب للمحفزات الواقعية بشكل غريزي؛ فالواقع أن الحالتين قد تشتبهان خاصة لكونهما يلتقيان في التزام الانخراط في الواقع، ومحاولة التأثير عليه، لكن شتان بينهما، ذلك أن الهم النضالي مرتبط بتحقيق أهداف مباشرة لا تشترط استصحاب “عالم الأفكار” بالضرورة، رغم حيويته، فالمناضل الذي لا يملك عالم أفكار معياري في نفسه فإنه غالبا يسقط في الأهداف المباشرة التي لا تخرج عن نطاق المصلحة الفردية والجماعية المحدود بالإدراك الغريزي الطبيعي الذي لا يعي البعائد ولا يلتزم المبادئ.
فالواضح أن الإنسان يجد نفسه في إطار طبيعي حده الأدنى المحيط الأسري القرابي، وحدّه الأعلى الوطن الجغرافي الذي يشكل هويته التاريخية-الطبيعية(2)، حيث الخصوصية الجزائرية هنا هي أن سعة الرقعة الجغرافية وانعدام سياسة وطنية شاملة، فضلا عن انعدام تيارات وحركات اجتماعية قاعدية مكينة، ولّد رد فعل شبه طبيعي عند الشباب وهو الانكفاء على المستويات الجهوية والإثنية كبديل عن فشل سياسة التحضر والتمدين الاجتماعية وفقدان الفاعلية الصناعية والاقتصادية، في ظل غياب لعناصر التوحيد السياسية، بل وحتى وجود سياسات مضادة للنماذج التي يمكن أن تحقق تجميعا على المستوى الوطني، وهذا أيضا ما جعل التمسك بنموذج فكري-أخلاقي وطني متعذرًا كتيار عام، إلا كجماعات مجهرية صغرى، رسمية وغير رسمية، لا تفتأ تنكفئ على ذاتها بعد انطلاق.
وإذا رفعنا مستوى رؤية التحليل وجدنا أنفسنا أمام العنصر الضروري المفقود لإعادة بناء شبكة علاقات اجتماعية على أساس فكري-خلقي كفيل بالتأسيس -ولو البطيء- لتيار وطني عام للنهوض، لذلك فإن هذا الواقع أنتج انقساما أساسيا بين:
1- أصحاب الهم الفكري-الخلقي الذين تحولوا إلى شبه أقلية من حيث الفاعلية رغم كثرتهم المفترضة.
2- أصحاب النضال الميداني على أساس طبيعي، حيث شكل الأخير القوة التي ما تزال فاعلة لما حازته من آليات التأثير والنفوذ، رغم كون أصحابه أقلية.
الأمر الذي أدى إلى انقسام الساحة الفكرية الشبابية إلى:
1- نموذج الشاب الجزائري المنكفئ والراضي بالوضع العام والمدافع عنه، نموذج الشرعية الثورية مثلا، من قبيل الحزب الواحد وشرعية أبناء الشهداء والمجاهدين بل وحتى أبناء المجاهدين.
2- نموذج الشاب الجزائري الساخط على الوضع الداعي إلى وضع أكثر طبيعية، نموذج التحيز الجهوي والإثني مثلا، التفاخر بالانتماء الجزئي وازدراء الانتماء الوطني مع بقية الإنتماءات، بل وحتى تفضيل الأجنبي على الأهلي.
بينما بقي النموذج العقلاني ذو المثل الفكرية والخلقية مقصى خارج حلبة التفاعل والتأثير، النموذج الذي يفترض به السعي للجسر بين المعطى التاريخي-الطبيعي وبين المثل الفكرية-الخلقية، حيث الفارق بين النموذج العقلاني الخلقي والنموذج الطبيعي الغريزي يكمن في كيفية تبني الموقف الفكري، فالموقف الثاني هو مجرد تلق وتقليد أصم للواقع وقبول به بغض النظر عما إذا كان تلقيا إيجابيا بقبول الحاصل أو تلق سلبي بمعارضته بنموذج أدنى من الحاصل، بينما نتج الثاني عن بناء عقلي ومنطقي يمكن تحديد إحداثياته بمعيارين اثنين، سيعد العمل دونهما نكوصا تاريخيا وعقليا، ويمكن اعتبارهما قيمتان مؤسستان:
1- قيم العقلانية: وتجسيدها في التمدن الجامع بين المادي والثقافي المفضي إلى تركيز “الأخلاق المدنية” التي هي مأصولة في القيم الفطرية الثاوية في الدين الأصلي.
2- قيم الفاعلية: وتجسيدها في المواطنة الجامعة بين الحق والواجب المفضية إلى تركيز “وطنية براغماتية” التي هي مأصولة في القيم الفطرية الثاوية في الحضارة الراهنة.
بذلك، يكون الشأن الفكري المتأرجح بين الوجود والعدم في الجزائر قد عرف أهم معوقاته وتلمس طريق استئنافه، بوصفه الشرط الأساسي الضروري لتحقيق اللحمة الاجتماعية السياسية بين الشباب الجزائري، وقبل ذلك التخلص من الحس الطبيعي الغريزي الذي ساهمت عقود التيه في ترسيخه، إلى أفق الحس الفكري الخلقي الذي يجب أن يستعاد كحق مستلب، استلب معه الإنسان الجزائري، ولعل هذا شرط شروط النهضة الجزائرية المأمولة كجزء من كيان أعلى، وعلى المنوال يجب أن يحذو الجميع سواء من المحيط إلى المحيط، أو من طنجة إلى جاكرتا. د. محمد عبد النور 24/05/2023
(1)- أيضا قد تشير دلالة الشأن الفكري بالبقاء في موقع المتابع الخارجي لمضمار المعرفة الإنسانية من دون تخصصية، حيث يمكن عد العلوم الإنسانية والاجتماعية هي المجال الأمثل للمتابعة الدقيقة، سواء ما تعلق بتحصيل الأبجديات أو بمتابعة التطورات والوقوف على ذرواتها، وهذا يجعل المهتم بالشأن الفكري شبه مختص، وقد يتصدى لتقديم الرأي والأحكام دون اكتمال التكوين، حيث الواجب هنا أن يتبين المرء منزلته في السلم المعرفي لالتزام متاحاته لئلا يجترئ على ما لا طاقة له به من الأفكار والأطروحات في المجال..
(2)- إذا اعتبرنا الأسرة والوطن الحدان المتطرفان للهوية الطبيعية الفردية، فإن الفرد والأمة هما الحدان المتطرفان للهوية الخلقية للإنسان، ذلك أن الفردانية تتحول كوعي وممارسة من حال الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل عند استعمال القدرات الفردية العقلية والنفسية والبدنية بالابتعاد عن التلقي السلبي للنمطية الفردية إلى العمل الإبداعي الفاعل، كذلك الأممية (الكونية) تتحول كوعي وممارسة من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل عند تحقيق القيم الدينية والثقافية والسياسية بالابتعاد عن التلقي السلبي للنمطية الجمعية إلى العمل الجماعي الفاعل؛ فتكون المعادلة: فرد+أسرة+جماعة وطنية+جماعة كونية، بحيث تستحيل الأسرة إلى مجال لتخريج الفرد الحر فكريا والسوي نفسيا، كما تستحيل الجماعة الوطنية إلى وحدة أولية في سبيل تحقيق الجماعة الكونية.

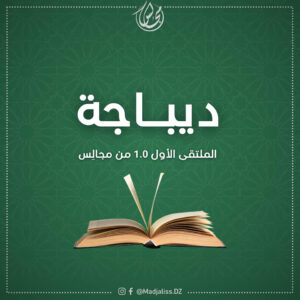

لا توجد تعليقات بعد